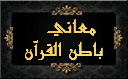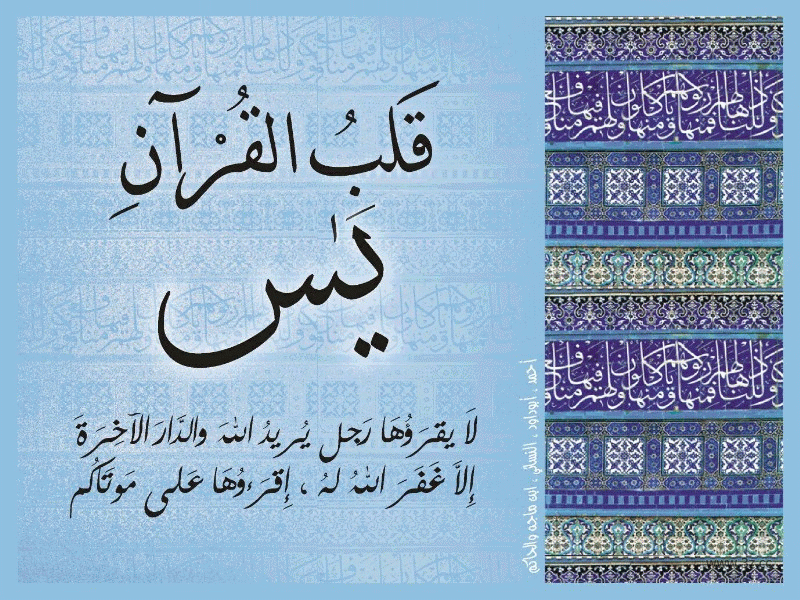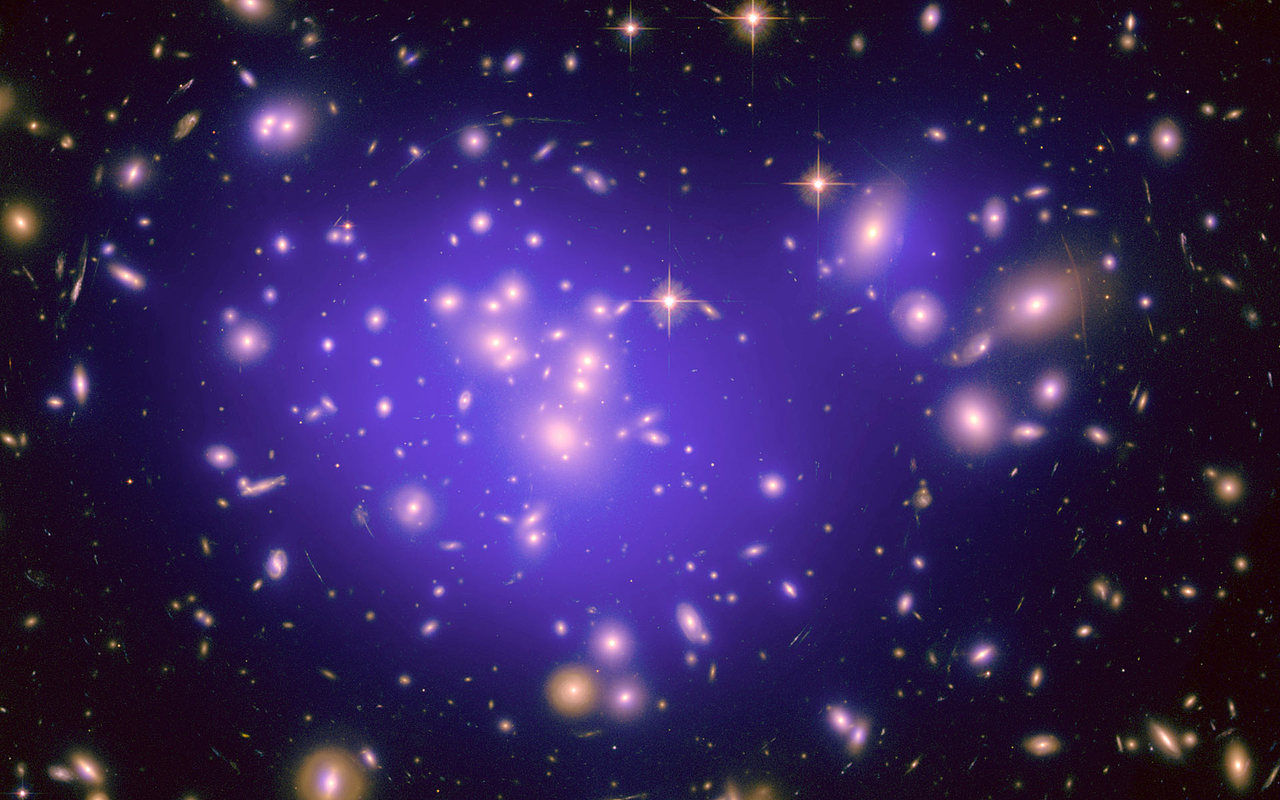



السبع المتاني
قال تعالى:
1. {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}: لما شاء الله أن يتجلى بصفاته في ذاته، عيّن المرتبة الحاكمة على مختلف التعينات، وأسماها باسمه "الله"؛ وأوكل إليها إعطاء كل صفة حظها، وكل اسم نصيبه من التجليات. فكان افتتاح ظهور مكامن الذات بالاسم "الله" لا بسواه. ولما كانت غاية هذا التجلي رحمة الأسماء بظهور مقتضياتها، وعموم تلك الرحمة للوجود علوا وسفلا، منة واختصاصا، فقد جاء بذكر "الرحمن الرحيم" بعد الاسم الله، حتى يُعلَم الكتاب من عنوانه، فيطمئن السامع إليه، ويسكن روعه؛ لأن العبد لو تُرك من غير إيناس، لأخذته هيبة الكلام الإلهي وجلاله، حتى يتحلل تركيبه وينفصل عنه إدراكه. لا شك أن المراد من كلام الله بعد الإسماع حصول الوعي للمعاني، حتى يتم العلم بحصوله في مرتبة الحدوث بعد ثبوته في مرتبة القِدم. وهذا هو سبب عقل الأرواح لمعاني الكلام. و"الرحمن" هو صاحب رحمة الامتنان، وهي عامة؛ و"الرحيم" هو صاحب رحمة الاختصاص.
2. {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}: الحمد من جميع المراتب التي تعينت بالاسم الله بجميع الأسماء لله الذي أظهر حدودها، وعين لها مجال تصرفها في العوالم التي هي آثارها. وقد جاء "الرب" مضافا للعالمين، بسبب عدم انفصال الأثر عن المؤثر الذي هو ربه. وتربية الرب للعالمين، هي بكل اسم تجلى به الله. فمنها ما ظهر أثرُه في الدنيا، ومنها ما سيظهر في الآخرة. فمن هذه الدوائر كلها، يكون الحمد من الله بأسماء الربوبية لنفسه في مرتبة الألوهية. فهذا الحمد حمد إجمال التفصيل، لا حمد التفصيل. فلا ذكر للحامدين هنا إلا من حيثما هم مظاهر للأسماء لا غير. وهذا من البشارة لأشخاص العالم بالرحمة؛ لأن من كان صدوره من الله، فلا يمكن أن يُنظر إليه –ولو بعد حين- إلا بالبراءة من كل ذم.
3. {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}: بتكرار "الرحمن الرحيم" ووروده بعد ذكر العالمين، يثبت المآل إلى الرحمة بعد أن كانت علةً للتجلي. وعلى هذا تكون الرحمة محيطة بالعوالم.
4. {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}: اليوم هنا بمعنى التجلي الخاص بالآخرة؛ حتى لا يظن ظان أن التجلي محصور في يوم الدنيا، من كونه المشهود للحواس. وبهذا تكون أيام التجلي العامة يومين: يوم الدنيا، ويوم الآخرة. وقد جعل الله يوم الآخرة يوم ظهور مقامات الخلائق، والفصل بينهم فيما اختلفوا فيه من مقولات، حتى يَبين المخطئ من المصيب، والمتوهم من العالم. وجعل أمر هذا اليوم لاسمه الملك، حتى يُفهم منه أن لا شيء مما يعتدّ الناس به في العادة من مكانة عند أنفسهم، أو جاه، أو مناصرة قوة أو عدد، يمكن أن يكون معتبرا. وإذا كان الله مالكا ليوم الدين، الذي هو يوم الفصل والحكم، فإنه ليوم الدنيا أملك؛ لأنه من يملكْ النتائج فإنه للمقدمات أملك. وهذا المعنى يشير إلى ما سيعرض للناس من تشعيب واختلاف، يصعب عليهم معه أن يعرفوا دائما ما هم عليه من أمر؛ وهل هم على حق أم على باطل.
5. {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}: المتكلم هنا العباد. وقد جعل الله الكلام في أول سورة من سور القرآن وفاتحته، مقسوما بينه سبحانه وبين عباده. والسورة هي المنزلة (المرتبة). فسورة الفاتحة، هي مرتبة الحقيقة المحمدية، التي جعلها الله جامعة للحقائق الحقية والحقائق الخلقية. وهي نفسها القرآن من حيث الإجمال، وقد سماها الله أم الكتاب من هذا الوجه. وكلام الخلق هنا من حقائقهم في الأم. فقالوا بلسان الحال قبل لسان المقال: إياك نعبد. وأسبقوا ذكر الله على ذكر أنفسهم المضمر في ذكر فعلهم، وفق ما تعطيه مرتبتهم التي تقتضي أن شهودهم أنفسهم، يسبقه شهود الحق الذي هم قائمون به. والشهود هو ما جاء بكاف الخطاب، وهو من المواجهة. وقد جاء ذكر العبادة بصيغة الفعل، حتى يدل على أن كل ما يصدر من العباد هو عبادة، بصرف النظر في هذه المرتبة عن كونها مشروعة ومما يسمى عرفا عبادة، أو هي مما يخرج عن دائرتها. ويدخل ضمن هذه العبادة، عبادة الاختيار (الشرعية) وعبادة القهر العامة. وهذا يجعل العباد كلهم عابدين لله، مؤمنهم وكافرهم؛ نعني قبل ظهور الإيمان من المؤمن والكفر من الكافر. أما قول العباد: وإياك نستعين؛ فهو دال على العجز الأصلي التام. وإخراج ما في العلم الإلهي من أحوال وأفعال العباد، هو من الله لا من أنفسهم. فهذه هي إعانته لهم سبحانه. ولولا هذا، لبقيت أحوال العباد في طي العدم. ولما انتهى الأمر إلى ذكر أحوال العباد التي تعود في أصلها إلى أسماء الجمال وأسماء الجلال، جاء الدعاء بالهداية إلى أقوم طريق بقول الله تعالى:
6. {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ}: ولا صراط من دون غاية، فالصراط المستقيم هو أقصر طريق إلى الله. هذا يعني أن هذا التجلي القرآني، إنما غايته معرفة الله لا غير. ومن عرف الله بعد شهوده العالم، وشهوده نفسه، فقد هُدي الصراط المستقيم؛ أما من بقي مع العالم ومع نفسه، فقد عُدل به عنه وانحرف.
7. {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}: الصراط المستقيم، هو صراط المنعم عليهم؛ في إشارة إلى المشيئة الحاكمة على العباد في الأزل. فهناك وقع التمييز بين السعيد والشقي، وقبل بروز أسباب السعادة والشقاء إلى الوجود؛ لأن المشيئة هي المستدعية للأسباب لا العكس. فمن وجد نفسه من المنعم عليهم، فليشكر الله الذي تفضل عليه وجعله على تلك الصفة من غير سبب منه؛ ومن وجد غير ذلك من المغضوب عليهم أو الضالين، فلا يلومن إلا نفسه. وقد جعل الله في هذه الآية أصحاب السعادة قسمين، وأصحاب الشقاء قسمين. فأهل السعادة أعلاهم أصحاب الصراط المستقيم، وهم العارفون بالله المحققون وعلى رأسهم الأنبياء عليهم السلام؛ وأدناهم من اتبع صراط المنعم عليهم، فكانوا منهم كالمأمومين من الإمام. وأما أهل الشقاء، فأعلاهم (أشدهم شقاء) المغضوب عليهم، وهم من سيبرزون بصفات الربوبية ينازعون ربهم فيها؛ وأدناهم الضالون الذين طلبوا الحق فأخطأوه. وهؤلاء من الأولين أيضا كالمأمومين من الأئمة. فتبين أن سالكي طريق الحق أئمةٌ ومأمومون، وسالكي طريق الباطل أئمة ومأمومون؛ والأئمة دائما لهم على أتباعهم درجة.
ولما كانت هذه السورة بين حق وخلق، فقد أعطت صراطين: الصراط المستقيم المفضي إلى الله، إما معرفة وإما إيمانا؛ وصراط الباطل الذي هو الوهم، الذي غايته العدم الذي هو أصل المخلوقين. وهذا الصراط غير مستقيم، من كونه يمر على العدم. وهو صراط أيضا، لأنه موصل إلى الغاية، وإن كان عن بعد وطول. وهو موصل لأن الحق محيط بالعدم؛ فبعد العدم يصل الضال إلى الحق الذي وجده العارفون عن قرب، وإن كان أوان اعتباره قد فات.
أما الآن فاعلم أن كل سورة من القرآن بعدُ، فهي مرتبة من مراتب الفاتحة التي هي الحقيقة المحمدية؛ وكل آية من الآيات هي تجل من تجليات الأسماء التي هي عينها الشؤون الإلهية. لذلك، فمن قال إن كل ما بعد الفاتحة هو تفصيل لها، فقد صدق.